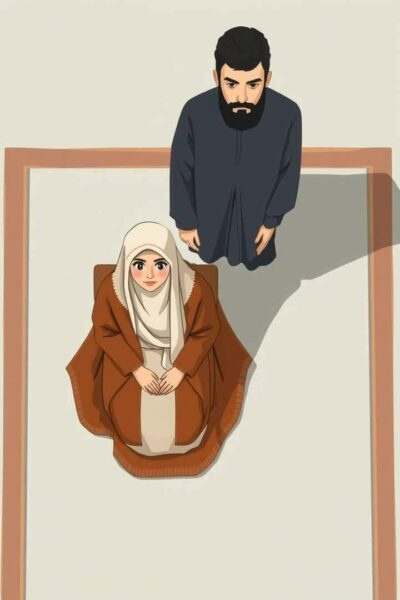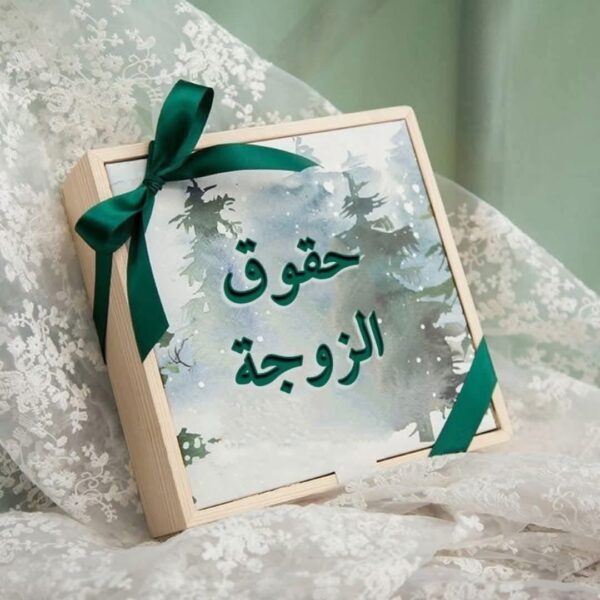مقدمة
عقد الزواج في الإسلام يُنظِّم العلاقة بين الرجل والمرأة، ويُقيم أسس الأسرة المسلمة. وليكون هذا العقد صحيحاً ومُستوفياً للشروط الشرعية، لا بد من توافر أركان أساسية اتفق عليها الفقهاء مع بعض الاختلافات في التفاصيل بين المذاهب. وفيما يلي بيان لأهم هذه الأركان:
- ١. الصيغة (الإيجاب والقبول)
* المعنى: التعبير الصريح والواضح عن رغبة الطرفين في إبرام عقد الزواج وإحداث أثره القانوني والشرعي.
* الإيجاب: يصدر عادةً من ولي الزوجة (الأب أو من ينوب عنه) أو من الزوجة نفسها إذا كانت راشدة ولها حق تزويج نفسها حسب المذهب. مثل قول الولي: “زوجتك ابنتي فلانة”.
* القبول: يصدر من الزوج أو ممن ينوب عنه قانوناً. كأن بقول الزوج: “قبلت تزويجها لنفسي” أو “تزوجتها”.
* الشروط:
– الصيغة الصريحة: يُفضل استخدام ألفاظ واضحة تدل على الزواج مثل “زوجتك” و”قبلت” أو “أنكحت”. ويُكره استخدام ألفاظ الكناية (مثل: وهبتك نفسي) دون نية الزواج.
– الاتصال: يجب أن يتصل القبول بالإيجاب اتصالاً مباشراً في مجلس العقد نفسه، دون فاصل طويل يُعد انصرافاً.
-الموافقة: يجب أن تكون الصيغة نابعة عن رضا واختيار كاملين من الطرفين (الزوج والزوجة) دون إكراه أو غش.
٢- العاقدان (الزوج والزوجة):
* الزوج: يجب أن تتوفر فيه شروط عامة مثل:
– الإسلام: (إذا كانت الزوجة مسلمة، وأما الكتابية فتجوز للمسلم بإجماع).
– الذكورة: فلا يجوز زواج الرجل من رجل.
– التحديد: أن يكون معيناً ومعلوماً.
– الإمكانية: أن يكون قادراً على تحمل تبعات الزواج (لا يشترط الغنى ولكن يُستحب).
– عدم وجود الموانع الشرعية: كأن يكون محرماً عليها تحريماً مؤبداً (كأخيها أو أبيها) أو مؤقتاً (كأن يكون في عدة من غيرها أو محرماً بالرضاع).
-الزوجة: يجب أن تتوفر فيها شروط عامة مثل:
* الإسلام أو الكتابية: (للمسلم فقط).
* الأنوثة: فلا يجوز للمرأة أن تتزوج امرأة.
* التحديد: أن تكون معينة ومعلومة.
* عدم وجود الموانع الشرعية: كأن تكون محرمة على الزوج تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً، أو أن تكون في عدة من زوج سابق، أو مُحصنة (زوجة لغيره) إلا بعد الطلاق أو وفاة زوجها وانقضاء عدتها.
* الرضا: وهو شرط جوهري لأصالة العقد.
٣. الولي (عند جمهور الفقهاء – الحنفية تخالف في اشتراطه للبالغة الرشيدة):
* المعنى: هو الرجل البالغ العاقل المسلم (عند الجمهور) القادر على التصرف، الذي له ولاية شرعية على المرأة في أمر تزويجها.
* ترتيب الأولياء: يبدأ بالأب، ثم الجد للأب (أبو الأب)، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، وهكذا الأقرب فالأقرب. ثم ذوو الأرحام، ثم ولي السلطة (القاضي).
* دور الولي: يقوم بإجراء عقد الزواج نيابة عن المرأة أو بموافقتها، والسهر على مصلحتها واختيار الكفء لها.
* الخلاف: ذهب جمهور الفقهاء (المالكية، الشافعية، الحنابلة) إلى أن الولي ركن في صحة عقد الزواج للمرأة البكر أو الثيب، مستدلين بحديث: “لا نكاحَ إلا بوليّ وشاهدَيْ عدلٍ” (صحيح الجامع). بينما ذهب أبو حنيفة إلى أن المرأة البالغة الرشيدة (الثيب والبكر) تستطيع أن تزوج نفسها بنفسها، ويكون الولي مستحباً فقط، وليس ركناً.
٤- الشهود:
* المعنى: ركنان عدلان يشهدان على إجراء عقد الزواج ويسمعان الإيجاب والقبول.
-العدد: شاهدان.
-الصفات: يشترط فيهما:
العدالة (عند الجمهور) أي أن يكونا مسلمين بالغين عاقلين، معروفين بالصدق والأمانة، غير فاسقين.
الذكورة: (عند الجمهور) فلا تكفي شهادة النساء في عقد الزواج.
-الحضور: أن يحضرا مجلس العقد ويسمعا الإيجاب والقبول أو يُعلما بهما علماً يقينياً.
-الغاية: تحقيق الإعلان عن الزواج ومنع الكتمان، وتوثيق الحقوق، والاستدلال على العقد عند النزاع.
خلاصة
لصحة عقد الزواج في الإسلام لا بد من توافر أركانه الأساسية وهي؛ صيغة واضحة تعبر عن الإيجاب من ولي الزوجة (عند الجمهور) والقبول من الزوج. عاقدان (زوج وزوجة) مستوفيان للشروط الشرعية وليس بينهما موانع. ولي للمرأة (عند جمهور الفقهاء: المالكية، الشافعية، الحنابلة). وشاهدان عدلان يشهدان على إجراء العقد.
وأن يتم كل هذا برضا واختيار كاملين من الزوج والزوجة، فهما أساس العقد. وتختلف بعض التفاصيل في شروط كل ركن وحكمه بين المذاهب الفقهية، لذا يُستحب استشارة أهل العلم الموثوقين للتأكد من صحة العقد وفق المذهب المتبع.